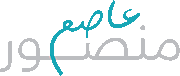أين أخفقنا…؟!

سؤال يتردد على ألسنة كثير من المراقبين والمتابعين لما يجري، وفي الواقع هو سؤال مشروع: فنحن عندما نبحث عن مواطن الخلل، لا نفعل ذلك من باب توجيه أصابع الاتهام أو إدانة جهة ما أو شخص ما، وإنما هي محاولة لتلافي الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلاً: فعندما نواجه ظرفا مستجدا، فلا شك سنكتشف ثغرات، وهنات. كما أنه من غير العدل محاكمة حدث ما بعد وقوعه، أو قرار ما بعد صدوره، حيث تكون المعطيات غير تلك التي كانت عليه ساعة اتخاذ القرار فنحن جميعا لا تنقصنا الحكمة بأثر رجعي.
لكن لو قدر لي أن أضع أصبعي على موطن الخلل الأهم في تعاملنا مع جائحة كورونا، لقلت ودون تردد أنه في إدارة الإعلام والتواصل مع المواطنين.
فقد لمسنا وعشنا يوما بيوم منذ بدء الجائحة، تعدد المراجع ومصادر المعلومات: والتي كانت متضاربة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى شابها سوء التنسيق، مما خلق أزمة ثقة حقيقية، جعلت المواطن يشكك بالمعلومة الرسمية ووجد أصحاب نظرية المؤامرة فرصة سانحة لاستغلال هذه المعطيات واللعب على التناقضات فيها لتمرير أفكار وإشاعات كان لها تأثير سلبي كبير على كيفية تعامل المواطن مع الوباء.
كما يلعب الشخص المخول بايصال الرسائل دورا محوريا في تقبل الناس لها، فالمرسل هو أحد أكثر العناصر أهمية من حيث إحداث التأثير المتوخى في السلوك البشري؛ إذ يستجيب الناس للرسائل التي يتلقونها من خبراء معروفين، ويتجاهلون تلك التي يتلقونها من أشخاص يفتقرون إلى الخبرة وتنقصهم القدرة على الإقناع، فلا يثقون بهم، ولا يأخذونهم على محمل الجد!
وغالبا ما تقع مسؤولية إيصال هذه الرسائل المعقدة على عاتق مصادر محددة كالعلماء والباحثين والأطباء الذين يشكلون أيضا مصادر رئيسية للمعلومات الموثوقة، والتي يستقي منها الصحفيون أخبارهم. لكن كثيرا من هؤلاء قد لا يكونون بالضرورة مؤهلين أو مدربين على التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أو في استخدام وسائل التواصل الأخرى.
فلا شك أن للإعلام سحره، وللكاميرا جاذبية شديدة يصعب مقاومتها، وقد تغشي الأضواء الأعين وتطلق المايكروفونات الألسنة من عقالها، وإذا لم يكن الشخص معدا لهذه المهمة فستكون النتائج كارثية.
أعتقد أننا كمسؤولين فشلنا في التعامل مع الإعلام، والاستفادة منه لبث المعلومة الصحيحة وبث رسائل التوعية، بل قللنا من شأن المتلقي، وتعاملنا معه بأدوات ومفردات القرن الماضي على طريقة أحمد سعيد، ونسينا أن هذا الجيل هو جيل الإنترنت وبإمكانه بكبسة زر كشف المُغالطات والتناقضات في خطابنا الإعلامي.
فأهم أساسيات الرسالة الإعلامية في مثل هذا الظرف الحرج أن نبتعد عن التعتيم وأن نلتزم الصدق، والموضوعية والشفافية في نقل المعلومة، وأن لا نجد غضاضة في قول “لا أعلم” اذا لم تكن المعلومة موثوقة، وأن لا نجعل اللوم أداة لاتهام الآخر بالتقصير، بيننا نحن الذين نمثل مؤسسات الدولة، وأن نوحد الخطاب الرسمي، وأن نقود بالمثل.
من المهم جداً لأي مسؤول أن يهتم بالتغذية الراجعة لأي قرار يتخذه، لكن الذي وقعنا فيه أننا رهنا بعض قراراتنا لردات فعل الشارع وكأننا نرسل رسالة مفادها أن هذه القرارات لم تكن مدروسة ولا تستند الى أي أسس علمية.
لقد كان لمُبالغتنا في التوقعات أكبر الأثر في فقدان ثقة المواطنين من خلال المبالغة في تقدير أعداد الضحايا والمصابين المتوقعين تارة، وفي الإعلان عن النصر المؤزر على الفيروس تارة أخرى: مما خلق حالة من الحيرة وعدم الثقة في أي معلومة أخرى قد تصدر عن هذه المؤسسات.
كما أسفر انتشار قنوات التواصل غير المنظَّمة وما رافقه من تنامي الشك لدى الجمهور وفقدانه الثقة بالعلوم ووسائل الاعلام التقليدية، والحكومات عن إيجاد بيئة خصبة لانتشار الإشاعات، والمعلومات المثيرة للجدل. فقد شهدت ثقة الجمهور في المؤسسات الصحية تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بل إن أكثر المختصين موثوقية، كالأطباء باتوا يحظون اليوم بثقة أقل بكثير من السابق بحيث لن يكون من السهولة بمكان استرداد هذه الثقة.