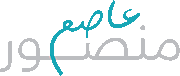دموع كاسياس وخيل الخليفاوي

15/07/2015
اجتذبت دموع حارس مرمى فريق ريال مدريد ايكار كاسياس، انتباه الملايين حول العالم. وحظي اللاعب بتعاطف كبير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. فخلف هذه الدموع، يكمن الشعور بالخذلان والظلم ونكران الجميل من قبل الفريق الذي أفنى اللاعب أفضل سنوات عمره مدافعا عن ألوانه.
ذكرتني هذه الدموع بقصة أخرى شهدتها قبل سنوات. إذ كنت في زيارة إلى دمشق، مع صديق لي، لتقديم المشورة الفنية لمستشفى للسرطان كان قيد الإنجاز، ولا أدري إن كان قد رأى النور حتى اللحظة. هناك، قابلت الشخص القائم على المشروع، وكان رجلا في العقد الثامن من العمر، قدموه لي باسم عبدالرحمن الخليفاوي. ولم يلفت هذا الاسم انتباهي، إلى أن عرفت لاحقا، في سياق الحديث، أنه رئيس وزراء سابق لسورية، ولمرتين، في حقبة السبعينيات.
حدثني الرجل بمرارة عن العقبات التي يضعها الكثيرون في طريق مشروعه الخيري، وعن عدم تجاوب أجهزة الدولة المختلفة معه. وكان واضحا، من سخريته المخضبة بالمرارة، مدى الألم والشعور بالظلم والتهميش والإهمال التي يعيشها هذا الرجل، الذي كان في مرحلة ما أحد أبرز الشخصيات في بلده. وقد بدا تهميش الرجل واضحا من أسلوب حياته، وسيارته التي كانت (كفارسها) قد خلفت وراءها أفضل سنين حياتها.
وختم حديثه بجملة قالها بلهجته الشامية الجميلة، وما تزال مطبوعة في ذاكرتي: “الواحد فينا لما يكبر لازم يعملوا فيه زي خيل الإنجليز… يطخوه”.
يقبع خلف كلا الشعورين، رغم اختلافهما في التعبير، شعور إنساني بالظلم والخيانة من قبل المؤسسة أو الدولة التي أفنى جزءا مهما من حياته في خدمتها، وكان يوما ما صانعاً فاعلا للحدث فيها.
ومن الصعب على الإنسان، خاصة إن كان معروفاً أو نجماً؛ سواء كان ذلك في الفن أو الرياضة أو السياسة أو حتى في مهنته، أن يجد نفسه فجأة وقد أصبح يعيش على هامش الحياة، مراقبا للأحداث التي طالما كان صانعا لها. ولهذا، نجد أن نسبة الاكتئاب والانتحار والإدمان عالية جدا بين أفراد هذه الشريحة.
ولا يشذ الأطباء عن القاعدة؛ إذ يصعب على الطبيب أن يجد نفسه فجأة بعيدا عن الممارسة التي اعتاد عليها طوال حياته. وهو ما يدفع معظم الأطباء إلى الاستمرار في المهنة حتى آخر أيام حياتهم. فالطبيب يشعر أن في تقاعده اعترافا بالفشل، وانسحابا من الحياة، فيما ما يزال لديه الكثير ليقدمه لمجتمعه ومرضاه. وهو ما دفع الكثير من الدول والمؤسسات إلى تمديد عقود أطبائها حتى بلوغ سن متقدمة. لكن المشكلة هنا تكمن في من سيعلق الجرس، ويرسم للطبيب الخط الذي يصبح تجاوزه خطرا عليه وعلى مرضاه. فالطبيب غير محصن من أمراض الشيخوخة؛ الجسدية منها والعقلية، وسيأتي لا محالة اليوم الذي يبدأ فيه الجسد بخيانته والذاكرة بخذلانه، ما يؤدي إلى صعوبة أو حتى استحالة ممارسته للمهنة.
غالبا ما تحاول الإدارات والزملاء النأي بأنفسهم عن مواجهة زميل لهم بهذه الحقيقة. كما تقصر القوانين المعمول بها عن معالجة هذا الوضع. لذلك، عمد الكثير من المستشفيات في الغرب إلى استحداث لجنة تقييم سنوي للحالة الجسدية والعقلية لأطبائها بعد تجاوز سن معينة. وتقدم هذه اللجنة توصياتها بحيث يتم تكييف العبء الذي يمكن أن يتحمله الطبيب (كماً ونوعا) وفقا لتوصية اللجنة.
أرى أنه لا بد لنا من مأسسة هذه العملية، بما يضمن كرامة الطبيب والاستفادة القصوى من خبرته، كما يضمن في الوقت نفسه سلامة المريض. فمن الظلم أن يكون العمر هو المحدد الوحيد لمدى قدرة الإنسان على العطاء، أو أن يترك هذا الموضوع لمجاملات الزملاء.