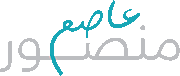“سقى الله تلك الأيام..!”

13/01/2016
تكفيني جولة قصيرة على “طرقات” مواقع التواصل الاجتماعي، للتدليل على ما يعتمل في صدورنا من شوق وحنين إلى الماضي، والبكاء على أطلاله. فهذا الكم الهائل من الصور القديمة للعائلة والأحبة والأصدقاء، والمناسبات الخاصة، التي يزدحم بها فضاء النت، ربما لم تكن تعني لنا شيئا وقت التقاطها أو الاحتفاظ بها بين أوراقنا في الأدراج المقفلة على الماضي بذكرياته وشخوصه ومكوناته. وتلك الأغاني القديمة التي نتبادلها، ونطرب لسماعها، ربما لم نكن نستمع إليها إلا قسرا عبر مذياع الجيران أو أثناء تنقلنا إلى وجهات مختلفة، حيث تحملنا وسائل النقل العامة، أو حتى مجرد استعادة وقائع حادثة ما بشغف كبير وتوقٍ إلى الماضي، بالرغم من أن تلك الحادثة قد تكون سببت لنا ألماً كبيراً وقت حصولها وتركت جراحاً لا تلتئم.
نحاول أن نعود إلى الماضي للهروب من الحاضر. ولن ينجح هذا الأمر إلا إذا قمنا بتجميل بعض من ذاك الماضي الذي يحتمل الذكريات السعيدة والحزينة أيضاً! وهذا ما يدفع بنا إلى التعامل معه بانتقائية تضفي على المشهد شيئا من الرومانسية والمثالية اللتين لم تكونا في الأصل جزءاً من المشهد، وإنما أضفناهما لنشعر بالرضا عن أنفسنا وتفاعلاتنا في ذلك الماضي الذي عشناه سابقاً. فنحن عندما نقارن بين الحاضر والماضي، نقوم بذلك بتحيّز؛ إذ نستحضر أفضل ما كان في الماضي، ونقارنه بأسوأ ما في الحاضر، فتكون المعادلة محبطة ومقلقة!
نهرب إلى الماضي عندما نعجز عن تغيير الحاضر، بحثاً عن ملجأ آمن وغير مكلف من ناحية معنوية على وجه الخصوص، نصنعه في خيالنا، ثم لا نلبث أن نصدقه. ونحبس أنفسنا داخله خشية أن ندفع ضريبة تغيير الحاضر أو حتى التصالح معه. وكلما أمعنا في تجميل الماضي، وفي إضفاء لمسة مغرقة في الرومانسية عليه، قسونا على أنفسنا أكثر في التعايش مع الحاضر، وازدادت تعاستنا واستحال علينا تغيير الواقع.
لو نظرنا إلى الماضي بصورة أكثر عمقا وموضوعية، وقبلناه كما هو، من دون تغيير، لاستطعنا تمييز وتقدير الصورة الحقيقية بدلاً من تلك الزائفة التي أجرينا لها عملية “فوتوشوب”. ولوجدنا أن بعض الأشخاص الذين كنا نظن بأنهم أصدقاء مخلصون لنا، وكانوا جزءاً من ماضينا، ليسوا سوى عابرين، طارئين على حياتنا، وبأن سنوات الدراسة الجامعية التي نحنّ إليها كانت مليئة بالمنغصات، والضغوطات، وضيق ذات اليد، وأن الأفلام والأغاني القديمة لم تكن أفضل؛ فمنها الجيد ومنها الهابط، إذ إن الحياة هي الحياة بنجاحاتها وإخفاقاتها، وأفراحها وأتراحها، تضحكنا حينا، وتبكينا أحيانا أخرى، لكن انتقائيتنا في تناولها هي التي تصنع الفارق.
البشر يملكون المقدرة على إعادة صياغة ماضيهم وجعله يبدو أفضل حالاً أو أسوأ. وبإمكانهم إضافة أي جزئية يشاؤون إليه، كلما شدهم الحنين، لتختفي الصورة الحقيقية بالتدريج تحت طبقات كثيفة متخيلة لم تكن جزءا من تلك الصورة.