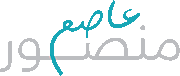موسم البحث عن “البوكيمون”

تجدهم في الشوارع والأزقة، وفي المقاهي، وفي جامعاتهم، وبيوتهم وأماكن عملهم، وحتى في سياراتهم… عيونهم مغروزة في هواتفهم الذكية، لا يكادون يرفعون رؤوسهم؛ ليس من باب غضّ البصر ولا الحياء، وإنما لانهماكهم بالبحث عن وحوشهم الصغيرة.
لعبة البحث عن “البوكيمون” (Pokemon)، لعبة مثيرة للجدل، شغلت العالم، وانتشرت كالنار في الهشيم مؤخراً، عابرة الحدود والأعمار، وإن شكّل الشباب والفتيات وقودها الرئيس؛ فقد حطمت في الأيام القليلة التي تلت إطلاقها أرقاما قياسية في عدد مرات التنزيل فاقت برامج وألعابا أخرى شهيرة، مما أدى إلى رفع قيمة أسهم الشركة المنتجة (Nintendo) بنسبة 77 % في غضون أسبوع واحد، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وهي التي كانت تعاني تعثرا في السوق! ولتحقق نجاحا غير مسبوق في عالم الألعاب الإلكترونية، مما سجل ما يقدر بـ15 مليار دولار أرباحا حققتها الشركة خلال أيام.
لقد فاجأ حجم الشغف بهذه اللعبة الجميع، بمن فيهم مخترعوها. حتى إن خوادم أجهزة الكمبيوتر في الشركة الصانعة لم تعد قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من المشتركين.
لقد جمعت هذه اللعبة (الظاهرة) بين العالم الحقيقي والافتراضي، وطعّمته ببعض الخيال، فتمكنت من زحزحة الشباب من أماكن كمونهم في عالم الواقع الافتراضي، إلى واقع معزز بالوهم، ليكتشفوا للمرة الأولى مدنهم وأحياءهم، ويقصدوا أماكن لم يصلوها من قبل.
لقد وجد الشباب فيها فرصةً للبحث عن أهداف متوهمة، في زمن فقدوا فيه أهدافهم الحقيقية. إذ جاءت هذه اللعبة لتخاطب فيهم غريزة الإنجاز والمنافسة وتحقيق الأهداف، حتى ولو كانت أهدافا افتراضية.
إن غالبية المهووسين بهذه اللعبة هم من الجيل الذي أحبّ القصة الأصلية لـ”البوكيمون” في طفولتهم، من خلال مشاهداتهم لها ضمن برامج الرسوم المتحركة، وعرف النسخة التسعينية من اللعبة. فجاءت هذه اللعبة لتحرك فيهم الحنين الى الطفولة، ووفرت لهم فرصة اللقاء بأصدقائهم الصغار المتحررين من سجن أجهزة التلفاز، ليجوبوا الأحياء والشوارع والأزقة والمتنزهات، وحتى دور العبادة، شوقا للقائهم.
قد يكون من الصعب على واحد مثلي عاش في زمن كان الهواة فيه يجمعون الطوابع والصور والعملات المختلفة، أن يستوعب استبدال كل ذلك بجمع وحوش رقمية. لكن من ابتدع هذه اللعبة يعي تماما سيكولوجيا وحاجات الجيل المستهدف بها.
فقد التقط مخترعو هذه اللعبة تعطش هذا الجيل لتحقيق أهداف قد لا تكون في متناولهم في الحياة الحقيقية، ليقوموا بإضافة بعض الخيال المحسوب إلى الواقع، علّهم يستطيعون إشباع شغفهم ومخاطبة الوهم الذي يملأ أرواحهم.
سيخبو بريق هذه اللعبة كما خبا بريق غيرها، لينتقل الشباب إلى لعبة أخرى تضفي مزيدا من الخيال على واقع أصبحوا فيه تائهين، يبحثون عن هدف أو إنجاز ما، وهم لا يدركون أنهم بينما يجوبون الآفاق، بحثا عن الوهم، ويلهثون في أثر السراب، إنما يسهمون في تضخيم ثروات هذه الشركات، وتحقيق أرباح لها تفوق الخيال.