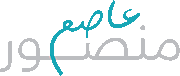“انظروا إلى السماء”

د.عاصم منصور
يوم جديد آخر لايقل رتابة عن سائر الأيام الأخرى، لكن نقطة مضيئة ظهرت على شاشة حاسوب (كيت) طالبة الدكتوراه في علم الفلك ستغير العالم مرة وإلى الأبد.
وتستعين كيت بالدكتور (ميندي) وهو عالم فلك مغمور، ليكتشفا بأن مذنباً كبيراً جداً على آخر أطراف المجموعة الشمسية، يتجه نحو الأرض وسيصطدم بها خلال 6 أشهر، لينهي الحياة على كوكب الأرض.
بهذا المشهد القلق والمفاجئ تبدأ أحداث فيلم ( لا تنظروا إلى السماء)، والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي، والفيلم قصة خيالية قدمت في قالب من الكوميديا السوداء، أراد صناعه إطلاق صيحة تحذيرية بشأن الأخطار الوجودية التي تواجه البشرية.
يعري هذا الفيلم واقعنا ويعرض للعديد من الإسقاطات على كثير من المواضيع والقضايا ويعكس لنا طرق تعامل الحكومات والشعوب مع القضايا الوجودية، لكنني لم أستطع قراءته بمعزل عن الخطر الأكبر الذي يواجه البشر في وقتنا الحالي في ظل «جائحة كورونا».
فالفيلم يعرض طريقة تعامل الإدارة الأميركية السابقة مع الجائحة، فالرئيسة الأميركية متحللة من كافة الأعراف والقيم، وقد صعدت إلى سدة الرئاسة عبر الإعلام الفضائحي، تزدري العلم والعلماء وتسخر منهم، وتحيط نفسها بالأقارب والمؤيدين، ترشح للمناصب الأنصار من المتطرفين غير المتخصصين، وترتبط بعلاقات فساد واسعة ودعم غير محدود من رجال الأعمال الذين يربطهم بإدارتها علاقة زواج غير شرعي، يمولون حملتها الانتخابية ويحصلون مقابل ذلك على نفوذ واسع يمنحهم صلاحية التأثير في عملية اتخاذ القرار والحكم.
وتتعامل هذه الرئيسة مع الكارثة من منظور مصلحتها الانتخابية فتهوّن من أمر اصطدام المذنب بالأرض، ثم تفكر كيف تستفيد منه وتستخدمه للتغطية على فضائحها مع قرب الحملة الانتخابية، مخافة التأثير على فرصة حزبها في الفوز في الانتخابات الوشيكة، وهذا ما حدث في ولاية ترامب عندما حاول أن يجير الجائحة لخدمة مصالحه السياسية والانتخابية، على حساب ارواح الأبرياء من شعبه.
وقد تناول الفيلم طبقات مختلفة من فئات المجتمع منهم العلماء والساسة ورواد التكنولوجيا والاقتصاد والإعلام الذي تم تصويره على أنه إعلام فاسد لا ينطق عن هوى الساسة وأصحاب النفوذ ويمارس إلهاء الناس بتوافه الأمور ليصرفهم عن المخاطر التي تحدق بهم، ولتحقيق الحصول على أكبر عدد من المشاهدين والإعلانات، يبحث عن الإثارة والربح على حساب الأخبار الرصينة والحقائق ويخضع لنفوذ من يدفع فواتيره.
كما يصور الفيلم العلم والعلماء على أنهم مرتبكون ولا يمتلكون وسائل التواصل ومعزولون عن الواقع الذي لا يفهمهم ولا يفهمونه، بل يتعرضون للسخرية والقمع لذلك تجدهم يعيشون على هامش الاحداث ولا يؤثرون فيها، تبهر بعضهم سطوة الكاميرا والأضواء وتسلبهم وقارهم، لكنهم لا يلبثون ان يعودوا الى رشدهم ورصانتهم عندما يزول تأثير الأضواء ويكتشفوا حقيقة العالم الذي لا ينتمون اليه لكن ذلك يحدث بعد فوات الاوان.
بينما يصور الفيلم أصحاب اليد الطولى في الدولة وهم الترليونيرات الجدد، رجال السيليكون فالي الذين يملكون الثروة المادية والمعلوماتية، مما يجعلهم يتحكمون بمفاصل الدولة وبقراراتها السياسية، وبالتالي يوجهون سياساتها لتخدم مصالحهم، ويتعاملون بفوقية مع باقي الفئات ولا يجدون فيهم سوى سدنة معابدهم، يجد هؤلاء في المذنب وما يحتويه من معادن ثمينة فرصة لمراكمة الثروة ولو على حساب المخاطرة بكوكب الأرض والفناء، فحتى الموت يجدونه فرصة لمراكمة الثروة.
وقد صور الفيلم المجتمع منقسما على نفسه مغيباً غارقاً في المتع، يتلاعب به السياسيون ويتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، سجين للهواتف الذكية ولشاشات التلفزة التي حادت عن الموضوعية وفقدت مصداقيتها على حساب تحقيق الربح المادي، فقد فقد هذا المجتمع البائس بوصلته ما بين التريندات وتحقيق اكبر عدد من (اللايكات) ، لذلك تراه منقسماً بين من «ينظرون إلى أعلى» ومن يرون في هذا مؤامرة شيوعية.
لقد كانت رسالة الفيلم قوية وواضحة في أنّ ما يهدد البشرية يكمن في صنع البشر أنفسهم، وما الأخطار الخارجية سواءً كانت على شكل وباء أو كارثة بيئية إلا الشرارة التي وجدت الوقود الكافي لاشتعالها؛ ورغم الصورة السوداوية التي رسمتها نهاية الفيلم لمآلات الكارثة؛ إلا أنني ما أزال متشبثاً بالعلم وستبقى عيناي معلقتين بالسماء.