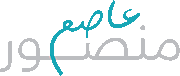غريب عن عاداتنا

13/05/2015
الوصفة الأسهل للهروب من مواجهة أي مشكلة، وتسطيحها، تكمن في التعامل معها كحالة معزولة، لا تستوجب البحث الجاد عن جذورها، بل الاكتفاء بالعلاج السطحي الذي يتعامل مع الألم الآني دون المسبب.
فما إن تهز مجتمعنا فاجعة، حتى يتسابق كثيرون إلى توصيفها بأنها “غريبة عن عاداتنا”، و”دخيلة على مجتمعنا”؛ وبأن من قام بها هي “فئة مندسة”.. إلى غير ذلك من العبارات التبريرية المكرورة، التي نعتقد أنها تكفينا مؤونة البحث عن حلول جذرية لها.
أسوق هذه المقدمة بين يدي الجريمة البشعة التي هزتنا، وذهب ضحيتها الزميل المرحوم الدكتور محمد أبو ريشة، أمام بيته وتحت نظر عائلته، على يد مجرم قيل إنه مدمن مخدرات.
ما الذي ننتظره حتى نسمي الأمور بمسمياتها؟ وكم من الضحايا مطلوب منا أن نقدم حتى نقتنع أننا أمام ظاهرة تستوجب المعالجة الجذرية؟ وهل علينا أن نكتب وصايانا ونودع أهلينا كلما غادرنا منازلنا متوجهين إلى أعمالنا، حتى ننزع عن هذه الظاهرة صفة “الغرابة”، وبالتالي نؤهلها لتحتل مساحة ما على أجندة صناع القرار؟
الاعتداء على الآخرين واستباحة دمائهم ظاهرة غريبة على كل الأنفس السوية، والمجتمعات المتحضرة. لكن ذلك لا يعني، بحال من الأحوال، الاكتفاء بتوصيفها، وعدم اتخاذ كل التدابير المتاحة من أجل الحد من انتشارها، وحماية حياة الأبرياء التي تشكل البند الأهم في بنود العقد بين المواطن والدولة، والذي تفقد الدول مشروعية وجودها في حال الإخلال به؛ إذ تتحول الدول إلى مستوطنات بدائية تسيّرها شريعة الغاب، حيث لا مكان للضعيف فيها إلا بين أنياب ومخالب القوي!لقد شهدت خلال سنوات عملي، العشرات من حالات الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لكن معظمها لم يتحول إلى شكوى، ولم يصل المحاكم. إذ يكفي أن تشهد مآل قضية واحدة، حتى تقرر الانسحاب ململماً جراحك، ليخرج المعتدي وقد أمن العقاب، باحثا عن ضحية أخرى. فعندما لا يكون لدى خصمك ما يخسره؛ لا من سمعته ولا من كرامته، تكون خسارتك محققة في أي قضية اعتداء يتم تحويلها في معظم الأحوال إلى “شجار”.
لقد قرع الأستاذ جميل النمري الجرس قبل سنوات، من خلال رسالة قوية وواضحة وجهها للحكومة، محذرا من استباحة المجتمع من قبل بعض “الزعران” وأصحاب السوابق. وأورد العديد من الأمثلة التي تحول فيها الضحية إلى مذنب، يبحث عمن يخلصه من “ورطته”!
حتى رجال الأمن يبدون، في كثير من الأحيان، بلا حول ولا قوة أمام سطوة المعتدين وأصحاب السوابق، ويبادرون الضحية بنصحية مخلصة، نابعة من معايشتهم للواقع، بأن “اسحب شكواك أنت مش خرج بهدلة”. كما أنهم هم أنفسهم ليسوا بمنأى عن الاعتداءات التي دفع العديد منهم حياته ثمنا لها.
لن ينقضي زمن طويل قبل أن تخفت أصوات المستنكرين، وينفض جمع المعتصمين، ويعود المضربون إلى أعمالهم، وتنسحب “بروفايلات” الحداد من مواقع التواصل الاجتماعي، ولتتواصل الحياة بانتظار حادثة جديدة، ستكون بالتأكيد “غريبة عن مجتمعنا وعاداتنا”. لكن الأكيد، أيضا، أن الحياة لن تعود كما كانت بالنسبة لزهرات خمس فتية، فقدن الحضن الدافئ الذي طالما منحهن الشعور بالأمن والطمأنينة؛ تصفعنا أعينهن البريئة التي استوطنها الحزن وانكسار اليتم، بسؤال يكاد ينطق من شدة الصمت: “بأي ذنب قتل؟”. وكذلك بالنسبة لجنين سيولد بعد أيام، وقد سقطت من قاموس مفرداته كلمة “بابا”.
الترجمة الفعلية والمؤثرة التي ترتقي لدرجة بشاعة الجريمة، لا تتحقق إلا بمراجعة القوانين المهلهلة التي توفر الحماية للمجرمين، والعارفين بطرقها الالتفافية، على حساب المسالمين. ألم يعلمونا منذ الصغر أن “القانون لا يحمي.. المحترمين”؟!