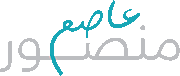قصة موت معلن

02/01/2016
كان ذلك في شتاء عام 1986.. وعلى غير عادة الطلاب وقتها، وجدتني أنساق لنداء داخلي ألحَّ عليَّ وأحزم حقيبتي مُيَمِّماً وجهي شطر الوطن، ساعات طويلة قضيتها واقفا أمام مكتب شركة الطيران الوحيدة التي كانت تحتكر حق تسيير الرحلات التي تصل العالم على جانبي الستار الحديدي متجمداً من برد موسكو القارص، علي أن أظفر بتذكرة على متن الرحلة الأسبوعية اليتيمة المتجهة إلى عمان..
بكثير من الحظ، وإن كان قد سانده ورقة من فئة المئة روبل سقطت “سهوا” بين دفتي جواز سفري ضمنت بها لنفسي مقعداً قبيل مغادرة الرحلة.
وصلت البيت على غير انتظار، حيث قابلتني وجوه الأهل مكفهرة تنبئ بخطب جلل، فبعد سلام مقتضب حاول الجميع سحبي خارج الغرفة والانفراد بي لنقل خبر إصابة جدي بالسرطان، محذرين من التحدث بهذا أمامه لأنه لا يعلم حقيقة مرضه.
كان جدي مستلقياً على فراشه في ركن الغرفة.. شبحا لذاك الشخص الذي كانت تتمحور حوله وتتكئ عليه حياتنا، حاول استجماع ما بقي لديه من طاقة ليعانقني وأنا أداري دموعاً فشلت في منعها من التفلُّت من مآقيها..
كان ذلك أول لقاء لي مع هذا المرض، ولم تسعفني محاضرات الكيمياء والأحياء والتي كانت كل حصيلتي من الطب وقتها في استيعاب كنه هذا المرض الذي لم يكن مطروقاً كثيرا وقتها.
كان الزوار يؤمون بيتنا، وكلما جاء أحدهم اصفرت وجوهنا خشية أن تفلت منه كلمة تخرق جدار الصمت والسرية التي ضربناه حول مريضنا حماية له من صدمة الخبر.
مضت الأيام والسنون سريعاً، ودار الزمن دورته ويشاء القدر أن يقربني أكثر من هذا المرض بالعمل في أحد أهم المستشفيات التي تعنى به، لكني ما زلت أجد جدي في كل مريض وفي كل تصرف نمطي لأهله الذي لم يتغير عبر السنين رغم زيادة معرفتنا بالمرض وتماسنا المستمر معه.
كلما شهدتُ هذا التصرف النمطي من قبل أهل مريض ابتلي بمرض خطير، يقفز إلى ذهني مشهد سانتياغو نصّار بطل رواية ماركيز الشهيرة “قصة موت معلن” يجوب شوارع البلدة، والجميع يرمقونه بعين الشفقة أو التواطؤ، وهم يعلمون ما يخبئُه له الإخوة التوءم، لكن أحداً لم يجرؤ على إخباره بالحقيقة. وبالتالي تواطأوا جميعاً على قتله ولم يبوحوا له بالمصير الذي ينتظره، وكأن هذا القتل المُعلن للجميع -إلا له هو شخصياً- وفقاً لدلالة عنوان الرواية، هو قدرٌ محتوم لا مفر منه. ومن شوارع تلك البلدة الكاريبية، وسانتياغو نصار، أعود إلى مريضنا وأتساءل إذا سار سانتياغو نصار في شوارع بلدة تآمرت عليه بصمتها، فأي طرق قد يطرقها مريض طريح الفراش، ومنْ نصّب الآخرين ليكونوا وصاة عليه، حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، وليقرروا عنه ما يجب ولا يجب أن يعرفه، وما الأخبار التي يستطيع احتمالها، وتلك التي لن يستطيع. أليس هذا الإنسان هو أولى الناس بمعرفة تفاصيل مرضه ومآل مصيره، وأحوجهم إلى اتخاذ بعض القرارات المصيرية التي تتعلق بحياته؟ وما الذي جعل من هذا المريض إنساناً لا حول له ولا قوة؟ هذا الذي كان قبل زمن ليس ببعيد يملأ الفضاء بصخب صوته، وضجيج حياته، هذا المريض الذي كان صاحب قرار في يوم من الأيام، وكان بمثابة مفصل أساسي في حياة كثيرين من حوله.. عائلته، اأصدقائه، عمله. واليوم هو عاجز بسبب المرض ومحروم من الإلمام بأبسط حقوقه كمريض يصارع الموت في فراش المرض.
هل إخفاء الأمر عنه، والتعامل معه كقاصر لا يملك من أمره شيئاً، وتنصيب الأهل أنفسهم أولياء عليه يحمل احتراماً وحبًّا له!
أظن بأن تصرفاتهم هذه هي تواطؤ مع المرض الذي يفتك به ويلتهم الزمن المتبقي له في هذه الحياة دون إدراك منه لما يجري حوله. هل كون الإنسان مريضاً ينزع عنه الأهلية، ويجعله أسيراً لعبث مشاعر الآخرين، المدفوعين خلف عواطفهم متناسين أن المرض لا يلغي قانون العقل والمنطق والحقيقة. والذين لا يدركون أهمية الوقت بالنسبة له في مثل هذه الحالة وما يمكن أن يفعله إذا ما قدر له أن ينجز حتى لو كانت تفاصيل صغيرة وتافهة.
أعلم أن نقل الأنباء السيئة هو علم وفن لا يمتلكه الكثيرون، وليس كل طبيب مؤهلاً لأن يفعل، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته. وأعلم أن تلقي الناس لهذه الأنباء يشي بردود أفعال مختلفة، لكني أومن في الوقت ذاته، أن من حق الإنسان أن يمتلك المعلومة الصحيحة عن حقيقة وضعه، وأن لا ننصب أنفسنا قيمين عليه.
وفي نهاية الأمر أنا لا أدعي أنني أمتلك الرأي الصواب في موضوع شائك كهذا يختلط فيه الأبيض والأسود، وما يخلفه هذا الخليط من ظلال. لكنني أجد نفسي منحازاً إلى كرامة الإنسان، وحقه في الحصول على المعلومة بمنتهى الشفافية والموضوعية اللتين لا يحدهما مرض مهما كانت خطورته.