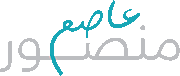السُنة كطائفة

20/01/2016
ليس في المعنى اللغوي لمصطلح “طائفة” ما يضير؛ فقد وردت الكلمة في القرآن الكريم والسُنّة المطهرة بمعان محببة، ربما دفعت بالبعض إلى التمسك بالمصطلح والحرص عليه. لكننا نشير هنا إلى الظلال والمعاني السياسية التي اكتسبها هذا المصطلح في العقود الأخيرة. فقد شكلت الحرب الأهلية اللبنانية منعرجا مهما في بروز الظاهرة الطائفية، من خلال ما عرف بـ”المارونية الانعزالية”، وحركة “المحرومين” الشيعية، والحزب الاشتراكي الدرزي، بينما نأى المكون السُنّي بنفسه عن هذه الحالة، مما حدا بالبعض إلى القول: إن “السُنّة ليست بطائفة”.
ربما كان السبب في أن السُنّة لم يتمثلوا الحالة الطائفية، نابعا من عدم شعور جمهورهم بخوف الأقليات على ثقافتها، ومصالحها السياسية، وحضورها الاجتماعي، ومصالح أفرادها، وانحيازها للإطار الأكبر، وأن تكون فوق المذهب، وأعلى من الطائفة، وحسابات السياسة، وأن تكون جزءاً رئيسا من التيار العام. وقد يكون هذا التفسير الأحادي لعدم “تطييف” السُنّة فيه مجازفة، إلا أنه لا يبعد أن يكون أحد الأسباب التي أدت الى عدم تكون المظهر الطائفي للسُنّة في لبنان في فترة اقتتال الطوائف، أو زعاماتها.
أما في الدول الأخرى غير لبنان، فكانت الحال أظهر. إذ بقي السُنّة -بشكل عام- تيارا عاما، ومظلة واسعة، تسعى إلى حماية روح “الجماعة” و”الأمة”، وتسعى إلى توسيع المظلة العامة، وحماية النظام السياسي والاجتماعي والديني بشكل عام. ولا نغفل أن الجمهور السُنّي الواسع كانت فيه على الدوام أفكار إقصاء وتهميش وتكفير، وفيه حتى من قَصَر المصطلح على ما هو أقل من طائفة، ولكن المذهب بشكل عام بقي المظلة التي تظلل الأمة أو الوطن، أو “أهل القبلة” بحسب السياق. ولذلك، رأينا الكثير من الطروحات الفكرية للمفكرين الإسلاميين السُنّة ذات مضمون جمعي غير مصطنع، يهدف إلى النهوض بالأمة بمكوناتها الدينية والمذهبية والثقافية كافة. ونذكر هنا، على سبيل المثال، الشيخ محمد عبده، ومحمود شلتوت والغزالي ومالك بن نبي وغيرهم. هذه الحالة فوق الطائفية، الواثقة، غير المسكونة بوهم الذوبان، وغير المتشنجة لهوية فرعية، هي من أساسيات استمرار الأوطان والأمم بالحدود الدنيا. وهي الدعامة للصمود والرافعة للنهوض. إلا أنه يبدو أنه قد أصابها في السنوات الأخيرة الكثير من التراجع، في ظل حالة الانكفاء والانشطار والتشظي، حتى يبدو وكأن الجسم الضخم في العدد والتنوع لم يعد بالثقة ذاتها، والثبات الممتد عبر تاريخ طويل هو تاريخ الأمة، ليصبح الخطاب المذهبي هو الشائع بل المتفرد، والخوف من المستقبل هو السائد، فتراجع أو تلاشى الفكر الوحدوي، لصالح الحديث عن مصالح المذهب والفئة، وأصبح منطق المحاصصة والانغلاق يزاحم منطق التحديث والانفتاح.
لا شك أن هناك أسبابا وظروفا موضوعية، داخل الأمة وخارجها، أدت إلى هذا التغيير. لكن أيضا هناك الكثير من التضخيم وسوء التدبير والفهم، وبالتالي الاستجابة. إذ ليس ثمة مصلحة في أن يكون هناك أي تحول عن الوسطية والانفتاح والتيار العام؛ هذه حقيقة يجب أن يتأملها كل حريص على أن تسير الأمة بالاتجاه السليم، سواء في مواجهة الظروف الاستثنائية المُعاشة أو في السعي للنهوض الحضاري. فلا يمكن لأمة أن تنهض نهوضا حقيقيا ومستداما بجزء منها مهما كبر هذا الجزء، بل النهوض يحتاج إلى شمول واستيعاب لكل المقومات والمكونات، وأهم هذه المكونات هو العنصر الإنساني.