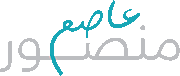صاحب الحاجة أرعن.. ولكن

ما زلت أذكر إصابتي بانزلاق غضروفي في فقرات الظهر، قبل سنوات قليلة، مما اضطرني إلى لزوم الفراش أياماً، تلقيت خلالها العديد من النصائح “الطبية”، تراوحت بين الكي واستخدام العصا الضاغطة على أسفل الظهر. لكن أغرب تلك النصائح كانت من صديق لي صاحب باع طويل فيما يسمى بـ”الطب الشعبي”، حيث أنه مبتلى بأحد الأمراض المزمنة التي ترتب على صاحبها الخضوع لبرنامج علاجي قاسٍ مدى الحياة، مما جعل منه خبيراً في مجال “الطب الشعبي”..
اقترح علي هذا الصديق، أن أذهب إلى إحدى القرى وأن آخذ غصناً من إحدى الشجيرات وأدفنه في كهف، وما إن يجف هذا الغصن حتى يختفي الألم. نظرت إلى ذلك الصديق طويلاً، وإلى وضعه الصحي الصعب الذي لا تخطئه العين متسائلاً لو كانت هذه الطرق تجدي نفعاً لما كنت على هذه الحال! وكان جوابه من يدري “ممكن تزبط معك”!
لقد لخص هذا الصديق بجملته الأخيرة لبّ الأوهام المؤسسة لما يسمى بالطب الشعبي، وهو أننا مختلفون، وأن ما لم يثبت فعاليته مع شخص، قد يفيد شخصاً آخر! فالمروجون لهذا النوع من الطب يلعبون على وتر الخوف، ويبيعون الأمل الكاذب، وتأثيرهم في مستمعيهم لا ينبع من جودة المنتج أو الحل الذي يروجون له، وإنما من قدرتهم على مخاطبة عواطف الناس، مستغلين حالة الإحباط وفقدان بصيص الأمل بالمنظومة العلاجية المعتمدة. فنجدهم يرتمون في أحضان أول من يعطيهم بارقة أمل، حتى ولو كان أملاً كاذباً. وقد تتحول العلاقة بين المريض والطب الشعبي إلى علاقة إدمان مرضية، والأدهى من ذلك أن الكثير من ضحايا هذه الممارسات يتبرعون مختارين ليكونوا مندوبي مبيعات بدون مقابل.
يحدثنا الأطباء عن عشرات الأمثلة التي تمر بهم من مثل هذه الممارسات: بعضها يفوق الخيال في غرابته، وربما طرافته: فهذا الذي يجري “عمليات جراحية” دون جراحة في مزرعة على أطراف المدينة، وآخر يعالج “البهاق” بتبخيرة على مرق “فرخة سوداء”، وثالث يبارك ماء الشرب بترياق بصاقة، ناهيك عن الذي يصف شرب مادة “الكاز” لعلاج السكري، وكثير غيرها من الممارسات التي لا يقبلها عقل، لكنها غالباً ما تجد من يبررها بـ”صاحب الحاجة أرعن”.
وهذا النوع من الخداع لا يقتصر على دولة أو منطقة دون أخرى، وإنما تجده ولكن بأشكال مختلفة في كل دول العالم المتخلفة منها والمتحضرة، والاختلاف بينها ليس في الجوهر وإنما في الشكل الخارجي، حيث تضفي الأخيرة لمسة من التحضر المزيف على ممارساتها.
لطالما حلم الأنسان منذ الأزل بحبة الدواء السحرية، تلك التي تحفظ الشباب أو تضمن الوقوع في الحب، أو تشفي كل العلل، أو تجعل منهم أبطالاً رياضيين، فتجدها جميعها حاضرة في الميثولوجيا الشعبية لكافة شعوب الأرض. وقد وعى مسوقو الوهم هذه الغريزة المتأصلة في البشر، فعمدوا إلى مخاطبتها في حملاتهم التسويقية سواء من خلال “الكريمات” التي تمنح البشرة شباباً لا يشيخ أو المكملات الغذائية التي تجعل منك بطلاً أوليمبياً، أو النباتات التي تقوي المناعة
وتخلص الجسم من السموم، أو حتى العطور التي توقعك في الحب، وهذه لا تختلف عن “العصا” أو “الكي” أو “الفرخة” إلا في الشكل لكن المبدأ واحد.
يحاول البعض التقليل من الأثر الصحي والمالي لهذه الممارسات لكن الحقيقة تخالف ذلك: فحجم الأموال التي تنفق على هذه الطرق تقدر بمئات المليارات، ويتنقل الناس في طلبها من بلد إلى آخر، ناهيك عن الأثر الصحي الذي لا يتوقف على إحجام المريض عن تناول العلاج الحقيقي، إنما يتعداه إلى الأضرار المباشرة لبعض هذه المركبات، والتي قد نستهين بها من منطلق “إذا ما فادت ما راح تضر”.
أعلم حجم المعاناة التي يسببها قصور الطب في إيجاد حلول ناجعة للكثير من العلل لكن ذلك لا يبرر أن يقع البعض فرائس بين مخالب تجار الوهم، فأنت إنما تعاقب نفسك على أمر لا ذنب لك فيه.
قد يقع العبء الأكبر في حماية الناس من هؤلاء المدعين على الجهات الرقابية لكن الإجراءات الرقابية تبقى قاصرة ما لم يتم تفعيل خط الدفاع الأول وهو الإنسان نفسه.