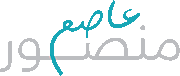محكومون بالأمل

يوليو 6, 2018
“رغم أنني حاولت معرفته -أي السرطان- خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنني ما أزال عاجزا عن تمثل معناه الحقيقي، هو عندي لا يمتلك سوى معنى مبدد الوهم؛ وهم الحياة الشقية التي نحاول أن نتصالح معها فترفضنا”. بهذه الكلمات المغرقة في التشاؤم ختم الصديق موفق ملكاوي مقالته في “الغد” والتي احتلت المساحة التي اعتدت أن أشغلها كل سبت، وكأن الأستاذ موفق أبى إلا أن تكون هذه المساحة وفية لتقاليدها من حيث الموضوع، لكن السؤال الذي يطرح هنا: هل يعزز الواقع هذه النظرة التشاؤمية؟
في مطلع العام 2016، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، شفاءه التام من أحد أخطر أنواع السرطان، وهو سرطان الجلد المنتشر إلى الكبد والدماغ، وذلك بعد خضوعه لجلسات علاج تنتمي إلى جيل جديد من الأدوية، وهو العلاج المناعي، فلو قدر الله أن يصاب الرئيس كارتر بهذا المرض قبل سنوات عدة لما كان بإمكانه العيش إلا أسابيع قليلة؛ حيث يعرف عن هذا النوع من المرض عدم استجابته لعلاجات السرطان التقليدية من كيميائي وأشعة، فيعمل العلاج المناعي على إعادة تأهيل الجهاز المناعي عند المريض لمهاجمة الخلايا السرطانية والقضاء عليها بكفاءة وأعراض جانبية قليلة نسبيا.
هذه الأدوية وغيرها أصبحت تحمل الأمل للمرضى بالشفاء من السرطان، أو على الأقل تحويله إلى مرض مزمن، تماما كما هي الحال بالنسبة لارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها.
كما كان لفهم العلماء والأطباء لجينات السرطان دور كبير في إنتاج جيل من الأدوية الجديدة التي تستهدف الطفرات الجينية في الخلية السرطانية، بحيث بات قريبا اليوم الذي سنكف فيه عن تصنيف أنواع السرطان المختلفة اعتمادا على موقعها التشريحي (الثدي، والرئة، والقولون،…إلخ) واستبدالها بتصنيف جديد يأخذ بعين الاعتبار نوع الطفرة الجينية المسببة له.
فالتطور السريع في تقنيات “التسلسل” جعل هذه التقنية في متناول اليد لكثير من الدول والمؤسسات، بل حتى الأفراد، فأصبحت الدول تستخدم قاعدة البيانات الضخمة الناتجة عن تحليل “الجينوم البشري” في التخطيط الصحي، وبناء استراتيجيات للوقاية من الأمراض الوراثية التي تنتشر في هذه الدول، كما شكل تحليل الجينوم الأساس لما بات يعرف بـ”الطب الدقيق”، فبعد مرور خمسة عشر عاما على إعلان نجاح العلماء في تحليل تسلسل الجينوم البشري، أصبح لدينا اليوم المئات من المشاريع الطموحة لتحليل الشيفرة الوراثية البشرية في أنحاء العالم كافة، وأصبح بمقدورنا ربط هذه الشيفرة الوراثية بالعوامل البيئية لفهم الاستعداد المسبق لدى الأفراد للإصابة بأمراض معينة، وبالتالي العمل على منع حدوثها أو تشخيصها مبكرا.
كما يمكن لبيانات السلوك البشري المحصلة من أجهزة الهاتف الذكية، عند ربطها ببيانات الصحة الموجودة، أن تعزز وبشكل كبير فرص التنبؤ بالحالات الصحية على المدى الطويل وتحديد نقاط التدخلات غير التقليدية، فضلا عن تصميم أدوات تشخيص أفضل، والوقاية من الأمراض، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض تكاليفها.
السرطان مرض معقد ولا يمكن مكافحته إلا بأساليب مبتكرة وبصورة شمولية تبدأ بالوقاية وتمر بالكشف المبكر والعلاج الموجه ثم الرعاية التلطيفية وتحسين نوعية الحياة.
لكن الأثر الأكبر الذي يمكن أن تحدثه يكمن في تداخلات أقل كلفة وتعقيدا وأكثر جدوى من خلال تغيير السلوك البشري سعيا خلف القضاء على عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، عملا بالقاعدة الذهبية “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.
لست من أتباع مدرسة بيع الوهم، لكنني مع إشاعة الأمل المستند الى الحقائق العلمية، فرغم أن الطب قد فشل في إحداث النتائج المرجوة في علاج بعض أنواع السرطان، إلا أنه قد غير خريطة معظم أنواعه وأصبحنا اليوم نتحدث عن نسب نجاح كانت أقرب الى الحلم قبل سنوات قليلة.